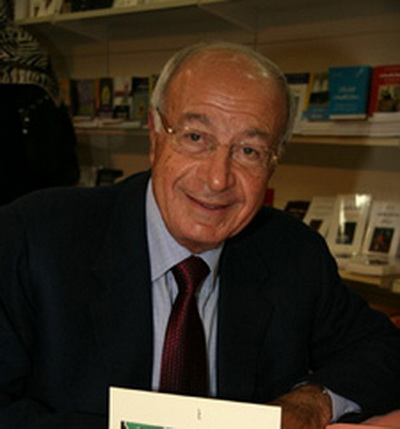غسق النظام الإيراني طويل الفصول
علي فائز
يرى معظم الإيرانيين الأميركيين، أن الأشهر الأربعة الماضية كانت مقلقة. فمنذ وفاة #مهسا أميني على يد #شرطة_الأخلاق في #طهران، خلال سبتمبر (أيلول)، شاهدنا آلافاً من مقاطع الفيديو لمتظاهرين غير مسلحين بغير شجاعتهم يقفون في وجه نظام عديم الرحمة.
لقد ارتجفنا من الرعب عند مقتل ما يقرب من 500 شخص، من بينهم أكثر من 60 طفلاً، بالذخيرة الحية، وإصابة مئات المتظاهرين بالرصاص المطاطي والكرات الحديدية، و#إعدام أربعة متظاهرين بعد اعترافات تحت التعذيب ومحاكمات صورية. ثم بكينا لأن عدداً كبيراً من خيرة الرجال والنساء قُتلوا في سبيل إطالة أمد حكم الشيوخ والمسنين القمعي. وأذهلتنا جرأة فتيات المدارس اللواتي أحرقن غطاء الرأس الإلزامي، وتحطمت قلوبنا حين شاهدناهنّ يذرفن الدموع على قبور أحبائهن. وينتابنا خوف من أن يتعرّض الآلاف الذين اعتُقلوا لأسوأ المصائر ويُسَرّى عنا لأجل الذين أُطلق سراحهم. وفي ضوء انتهاء جميع حركات الاحتجاج السابقة ضد ما يسمّى “الجمهورية الإسلامية” إلى مآسٍ نخشى أن تقتصر هذه الاحتجاجات على الدلالة على منعطف في التاريخ الإيراني، وتفشل في تحقيق أي تغيير.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، فقدت الانتفاضة بعض الزخم، وكانت الاحتجاجات متفرّقة وضئيلة نسبياً. وفي المقابل، لا يزال النظام على تشبثه بالسلطة، وهو نظام رهيب، وسيطرته شاملة على الإذاعات والفضاء الإلكتروني. وإلى الآن، لم تبلغ تحول الاحتجاجات مستوى يخوّلنا أن نعتبرها ثورة عامة. لكنها، على رغم ذلك، تشكّل التحدّي الأوسع انتشاراً والأكثر استدامة في إيران منذ عقود. فالتظاهرات هزت أكثر من 160 مدينة، وتخطّت الانشقاقات الاجتماعية والعرقية والطائفية. وذلك سعياً وراء هدف واحد: إسقاط النظام السياسي القائم. لقد حدثت ثورة فعلية في عقول الإيرانيين. ويتشارك الإيرانيون الآن إجماعاً عريضاً على كسرٍ أصاب النظام ويستحيل إصلاحه. فقد ولّت أوهام الإصلاح، وتحطّمت الآمال المعقودة على الأحلام الطوباوية، وعلى حصول معجزات اقتصادية وجدوى الصبر من أجل أيام أفضل. وما كان في يوم من الأيام نزوة منبثقة من ألم أو رغبة بعيدة المنال، ثم تحول إلى يأس مدمر، أمسى مطلباً لا رجوع عنه من أجل التغيير السياسي الجوهري والحرية.
لقد بلغت إيران اليوم الموضع الذي وصل إليه الاتحاد #السوفياتي في أوائل ثمانينيات القرن الماضي. فالنظام صفر اليدين أيديولوجياً، ويقف أمام حائط مسدود سياسياً. وهو غير قادر على معالجة مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية. ولا يزال يملك إرادة كافية للقتال، على ما اتضح من رده الوحشي على الانتفاضات. ولكن مهما كان مستوى القوة التي يستخدمها، فهي لن تنهي المواجهة مع الشعب، التي نجمت، في الأساس، عن إخفاقات النظام في جميع المجالات. ولم يبق سوى قليل من وعود، قُطعت خلال ثورة 1979، ببناء مدينة مشرقة وتقيّة في أعلى الهضبة [تكون مثالاً للعالم]. فعملياً، أنشأ النظام جمهورية خوفٍ متعسكرة، تمجّد الوضاعة وتعميم الكذب. وتعهد منشئو الجمهورية بتحقيق ازدهار متكافئ للجميع. ولكن، عوضاً عن ذلك، قصروا الوفرة على قلة قليلة، ودمّروا ما كان يوماً ما اقتصاداً مزدهراً. ووعدوا بالجنة على الأرض، إلا أنهم نشروا الجفاف على الأرض، ولوثوا الهواء، وهدّدوا بالذواء حضارة صمدت طوال 7000 عام.
الجمهورية الإسلامية اليوم، اسم مضلل وخاوٍ. وهي دولة دينية تولّت علمنة سكانها من غير قصد، وجمهورية هدمت القاعدة التشاركية التي توسّلت بها سابقاً إلى إضفاء الشرعية على حكمها. ولتضييق دائرة المقربين منه تدريجاً، همّش المرشد الأعلى علي خامنئي عدداً متعاظماً من الثوار الأصليين، وغيرهم من السياسيين الذين سعوا في وضع النظام على مسار أفضل. وقدَّم خامنئي شأن المتملقين على حساب الخبراء الأكفاء، وفضّل الموالين على النقاد المخلصين، ما أدى إلى أزمة كفاءة أوصلت البلاد إلى حافة كارثة اجتماعية واقتصادية وبيئية. ولم يبق مَنْ يتمتع بثقل سياسي، أو فطنة أو جاذب، لينقل الوقائع القاسية إلى خامنئي، البالغ من العمر، قريباً، 84 سنة.
والحق أن النظام أخفق في فهم مجتمعه الذي توسّع في الأثناء وتطوّر. وفي مماشاة أحواله الجديدة. ففي عام 1976، كانت إيران تُعدّ 34 مليون مواطن، يعيش فوق نصفهم في المناطق الريفية. وفي عام 2016، بلغ عدد سكان البلاد 80 مليون نسمة، اجتمع 75 في المئة منهم في المدن. وفي عام 1976، كان واحد من بين 230 ألف إيراني طالباً جامعياً؛ وفي عام 2016، بلغت هذه النسبة 1 من 20. وفوق نصف خريجي الجامعات هم اليوم من النساء. ومعدل البطالة بينهن ضعفا معدّلها في أوساط الرجال. والسكان الأكثر تحضراً وتعليماً يعانون ظروفاً معيشية مزرية جراء سوء الإدارة الكارثي، والفساد المستشري، والعقوبات الخانقة. ومن القبيل نفسه، يعيش واحد من كل خمسة إيرانيين تحت خط الفقر. وكان معدل النمو الاقتصادي في العقد الماضي أسوأ معدل شهدته البلاد منذ خمسينيات القرن الماضي.
وبناءً عليه، توقّع مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني أنه إذا نما الاقتصاد الإيراني، على سبيل الافتراض، 8 في المئة، وهو أمر خارج المطال، فلن يعود الاقتصاد إلى ما كان عليه في عام 2011، قبل عام 2026، فلا عجب في هذه الحال إذا سيطر اليأس على الإيرانيين.
وتُظهر الاستطلاعات الحكومية أن 83 في المئة من الإيرانيين غير راضين عن نوعية حياتهم. ولكن بدلاً من تحرير الاقتصاد (على ما فعلت الصين في العقود الماضية) ومن فسح المجال أمام الحريات العامة (مثلما فعلت بلدان أخرى، استمر أوصياء الجمهورية الإسلامية في إحباط الإصلاحات، وحالوا دون إحياء الاتفاق النووي. وكانت هذه فرصاً تؤدي إلى تخفيف العقوبات. لكنهم ألغوا الحريات السياسية الإيرانية، ومن بينها تلك التي كانت القوى الأكثر ميلاً إلى البراغماتية في البلاد تتمتع بها. وألغوا كل الوسائل التي تتيح للناس التعبير عن مظالمهم المكتومة، والتأثير في السياسة. ومضى النظام على مضايقة نصف السكان، وفَرْض قضية خاسرة، هي الحجاب الإلزامي، وجعل منها ركناً من أركان هوية الجمهورية الإسلامية.
وسعت الحملة القمعية في فرض الحجاب، بعد أعوام من التحرُّر الفعلي في ولاية الرئيس الإيراني حسن روحاني، (2013- 2021). وأظهرت بيانات استطلاعات الرأي أنه، في عام 2018، بلغت نسبة النساء اللواتي يرتدين حجاباً “غير شرعي”، 70 في المئة منهن. وعلى هذا، كان فقدان الحرية التي تذوقنها إلى وقت قريب في عهد الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، مؤلماً وموجعاً. ومن الواضح أن الشعب الإيراني استُفز بعد تداول صور، في الصيف الماضي، لأم يائسة تعترض سيارة دورية الإرشاد، وتتوسل إلى شرطة البلاد ألا تعتقل ابنتها المريضة التي زُعم أنها تجاهلت قواعد الزي الإسلامي، في “مركز لإعادة التأهيل”. وشعروا بالغضب، مرة أخرى، عندما شاهدوا اعترافاً متلفزاً بالإكراه لفنانة تبلغ من العمر 28 سنة كان من الواضح تعرّضها للتعذيب، متَّهمةً بارتداء ملابس غير محتشمة. وفي 16 سبتمبر، توفيت أميني، وهي شابة كردية تبلغ من العمر 22 سنة، في عهدة دورية الإرشاد. فأطلق ذلك العنان لسيل من الغضب.
الجنة والأرض
ونضال النساء الإيرانيات من أجل التحرر ليس حديث العهد. فمن طاهرة، الشاعرة التي خلعت حجابها في تجمع للرجالثلاثينيات القرن الماضي، إلى الاحتجاجات اليوم، صمد النضال في اختبار الزمن.
ويصدق الأمر نفسه في حال المعارضة الأوسع للسياسات الثيوقراطية. لقد فشل النظام الحالي في أسلمة المجتمع الإيراني على شاكلته وصورته، وخرج ذلك إلى العلن في إحدى ليالي نوفمبر (تشرين الثاني) 1997، بعد أقل من عقدين على اندلاع الثورة. ففي تلك الأمسية الباردة، فازت إيران وحجزت المقعد الأخير في كأس العالم لكرة القدم، في الصيف التالي بعد مباراة شيّقة ضد أستراليا. وعمّت البلاد موجة عارمة من الاحتفالات. كان الناس يتجولون وهم يطلقون أبواق سياراتهم ويستمعون بصوت صاخب إلى موسيقى البوب الفارسية المولودة في لوس أنجليس. وخلعت النساء أوشحتهن، ورقصن مع الرجال في الساحات العامة.
في ذلك الحين، كنت طالباً في المدرسة الثانوية، وأبلغ من العمر 17 سنة، وأعيش حياة مزدوجة، مسلِّماً بالقيود الدينية الإيرانية خارج المنزل، وبحسب المعايير الليبرالية داخله. وكانت تشيع طرفة تقول إن الناس قبل الثورة، صلّوا في الداخل واحتفلوا في الخارج، وصاروا يصلّون بعد الثورة في الخارج ويحتفلون في الداخل. وفي تلك الليلة، تخلى الناس عن هذا المثال. وفجأة، ضجّ البلد الذي كان ينفض عن نفسه ركام الخراب المتخلّف عن الحرب مع العراق، ولم يعمّه فرح كبير منذ وقت طويل، ولم يتمتع بمتنفسه، (ضجّ) بالحياة والطاقة. وسَرَت في أنحاء البلاد رغبة صريحة وملموسة في العلمانية والحياة الطبيعية، وطغت على ما تبقى من حماسة إسلامية وثورية.
وتجلّت تلك المطالب فعلاً على الصعيد السياسي في مرآة الانتصار المفاجئ الذي أحرزه الرئيس الإيراني محمد خاتمي، ونصّبه رئيساً، وفوّضه تفويضاً ساحقاً بإجراء إصلاحات اجتماعية سياسية، في بداية عام 1997. وفي أول مرة انتخبتُ فيها أدليتُ بصوتي لخاتمي. وكنتُ أعقد الأمل على ظهور فجر جديد من طريق التغيير المتدرّج، وليس الثوري. ولكن خامنئي، والهيئات غير المنتخبة الخاضعة لوصايته، بما فيها الحرس الثوري الإسلامي، خرّبوا أجندة خاتمي وعرقلوها. ولمّا كمّم النظام، في عام 1999، أصوات الصحافة التي حرّرها خاتمي بحذر، أشعل ذلك شرارة تظاهرات إيرانية، على غرار تلك التي حدثت في ساحة تيان ان مين (ببكين في 1989). وجنباً إلى جنب مع الآلاف من طلاب الجامعات الآخرين، نزلتُ إلى الشوارع احتجاجاً على القمع الذي مارسته الجمهورية الإسلامية. إلا أنّ قوات الأمن، واليمينيين المتطرّفين [الذين قرروا إنفاذ القانون بأيديهم] سحقوا حركتنا بعنف. وداهموا بيوتنا، واعتدوا بالضرب على المتظاهرين. وألقوا بعدد من الطلاب من فوق السطوح.
وبعد التخرُّج، واجهت قراراً صعباً: هل عليَّ أن أبقى أم أن أغادر. فإيران وطني، والبلد الوحيد الذي أعرفه. لكنها كانت في الوقت نفسه، دولة لا تسمح بالمشاركة السياسية، ولا تلبي تطلعاتي المهنية، وتضايقني على الدوام بسبب معتقداتي وأسلوب حياتي. وفي النهاية، غادرت، وانتقلت إلى سويسرا، في عام 2002، من أجل متابعة دراساتي العليا. ويلاحظ أنّ مئات الآلاف من خريجي الجامعات يهاجرون من إيران كل عام، ويأخذون القرار نفسه. ووفقاً لإحصاء حديث، فإن 71 في المئة من طلاب الجامعات في البلاد يلقون نظرة متشائمة على مستقبل إيران، و85 في المئة يريدون السفر إلى الخارج. وفي أثناء الاحتجاجات الأخيرة، كتب أحدهم على أحد الجدران: “ليس لدينا ما نخسره، سوى أغلالنا”، معلناً هذا المنظور القاتم.
واستمر الإيرانيون يناضلون، طبعاً، بعد مغادرتي. وفي عام 2006، جمعت النساء الإيرانيات مليون توقيع على عريضة تطالب الدولة بإلغاء قوانين تمييزية كثيرة. ولم يتسامح النظام مع أكثر أشكال الاحتجاج مدنية، فقاضى نشطاء الحركة وقادتها، ودمّرها في نهاية المطاف. وبعد سنوات، قام مجلس صيانة الدستور غير المنتخب، وهو يشرف على الانتخابات، بتزوير المنافسة الرئاسية عام 2009، ضماناً لإعادة انتخاب الرئيس الإيراني المحافظ جداً، محمود أحمدي نجاد، ما أدى إلى ثمانية أشهر من التظاهرات العريضة. وفي أيام الاحتجاجات الأولى، جاب ثلاثة ملايين شخص شوارع طهران بصمت. فأعمل النظام مرة أخرى قبضته الحديدية. وما عُرف مذذاك بالحركة الخضراء تعثّر في النهاية. ووُضع قادتها رهن الإقامة الجبرية، ولا يزالون إلى اليوم رهنها.
وتظاهرتُ في الشارع، في عام 2009، ولكن هذه المرة في بوسطن، حيث كنت أكمل زمالة ما بعد الدكتوراه. وأردت من إدارة أوباما التخلي عن المفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووي، وزيادة الضغط عليها. وكنت مهتماً منذ وقت قريب، بالسياسة الأميركية، وراقبت تفكير إسرائيل والولايات المتحدة في مهاجمة إيران من أجل كبح برنامجها النووي المتسارع. وكنتُ قلقاً من ابتداء مثل هذا الإجراء حرباً مميتة ومدمرة، من شأنها أن تسمح لأكثر عناصر النظام تشدداً بتشتيت الانتباه عن الموضوع الأساسي المتعلّق بالقضايا الداخلية، وبتعزيز سلطتهم، كما فعلوا أثناء غزو العراق لإيران في عام 1980. ثم انتقلتُ من وظيفة أكاديمية، في مجال العلوم، إلى عمل في مجال السياسة الإيرانية، عاقداً الأمل على أن أتمكن من مساعدة بلدي المضيف على تجنُّب الأخطاء التي ارتكبها في أفغانستان والعراق.
ووازى هذا التحول في حياتي المهنية تغيّرٌ في حسابات إيران. فسعى خامنئي، الذي أخافه الربيع العربي في عام 2011، في تجديد تأهيل النظام السياسي المتآكل وشرعيته بواسطة إجراء انتخابات رئاسية تنافسية (وفقاً لمعايير الجمهورية الإسلامية) في عام 2013. وفاز في المنافسة، آنذاك، حسن روحاني. وهو شخص مخلص ومطيع للنظام، لكنه، في الوقت نفسه، معتدل نسبياً، وكان ينتقد أساليب أحمدي نجاد المتطرفة. وفي عام 2015، وقّع اتفاقاً نووياً مع الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، معوّلاً على تخفيف العقوبات التي ابتلي بها الاقتصاد الإيراني. وفي عهد روحاني، كما كانت الحال في عهد خاتمي قبل سنوات، قضت الهيئات غير المنتخبة على الأمل في تحسين العلاقات مع الغرب وفي الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية. وأدّى تعاون الحرس الثوري الإيراني الساعي مع روسيا في سوريا، إلى الحفاظ على نظام الأسد، واعتقال البحارة الأميركيين الذين انحرفت قواربهم إلى المياه الإقليمية الإيرانية، واختبارات الصواريخ الباليستية الاستفزازية، (أدت) إلى تعكير صفو الأجواء. ولم يستطع روحاني الوفاء بوعده بالإفراج عن قادة الحركة الخضراء، ولا قدر على فرض ضرائب على المجمّعات التابعة للحرس الثوري الإيراني أو مكتب المرشد الأعلى.
وفي ذلك العام، زرت إيران لمناقشة الدبلوماسية النووية والإقليمية مع المسؤولين والخبراء الإيرانيين، بصفتي ممثلاً لمنظمة دولية معنية بالحؤول دون نشوب النزاعات. وسافر صديقي المقرب، سياماك نمازي، إلى إيران في زيارة عائلته. وعدت إلى الولايات المتحدة بعد أسبوع، ولكنّ نمازي لم يعد. وفي أثناء وجوده في طهران، اعتُقل بتهم وهمية بالتآمر لقلب نظام الحكم. ونُقل إلى سجن إيفين الإيراني السيئ السمعة. وهو هناك منذ ذلك الحين، ما يجعله أقدم المعتقلين الأميركيين في إيران. وكان اعتقاله بمثابة تحذير لي، ولأي شخص آخر كان يأمل في أن يكون الاتفاق النووي المدخل إلى قبول إيران عقد سلام مع العالم الخارجي، وليس الحد الأقصى.
وهكذا، أُغلق باب بلدي الأم في وجهي. وحين فقدت والدي بسبب مرض السرطان، بعد ثلاث سنوات، لم أستطع العودة. لقد حرمني جنون ارتياب النظام السرطاني في مزدوجي الجنسية، مثلي مثل كثيرين آخرين، من رؤية والدي قبل وفاته، ومشاركتي عائلتي الأوقات العصيبة، وحضور جنازة أحد أفراد الأسرة.
ألدّ أعداء نفسه
مهّد انتخاب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض لبدء حقبة عدائية جديدة في العلاقات الأميركية – الإيرانية، ولوقت عسير على الشعب الإيراني. ثم انسحب ترمب من الاتفاق النووي، في عام 2018، وأعاد فرض العقوبات على إيران، ووضع البلدين على شفير الصراع، وأراد تخيير النظام الإيراني بين أمرين: إما تقديم تنازلات حادة للولايات المتحدة في السياسات الخارجية والداخلية، وإما مواجهة الانهيار الاقتصادي. والحق أنّ نهج إدارته، الذي يُعدّ ثأراً أكثر منه استراتيجية، قد استخدم أدوات قسرية وعشوائية من أجل تحقيق غايات استراتيجية غير واقعية. فأدى إلى إفقار الإيرانيين، وشكك في الوقت نفسه في صدقية القوى البراغماتية داخل الحكومة الإيرانية، فأسهم بدوره في تقوية المتشدّدين ورسّخ مكانتهم.
وحاول خامنئي، مرة أخرى، احتكار السلطة، مستفيداً من أخطاء الولايات المتحدة. وبدا كأنه استنتج أن فشل أحمدي نجاد، وهو أدى إلى الخراب الاقتصادي وعزلة إيران، لم يكن بسبب مفهوم معتلّ بل بسبب شخصية معيبة. وفي انتخابات عام 2021، بدلاً من اختيار شخصية عصامية تستجيب لطلب شعبها، ولا تدين للرجل الذي يتولى القيادة، اختار شخصاً مجرباً وذا ولاء أعمى يدين له بكل شيء. وهذا الشخص هو رئيسي. وخلافاً لعام 2009، قام مجلس صيانة الدستور، في عام 2021، بتزوير الانتخابات قبل الاقتراع. فأقصى جميع منافسي رئيسي الوازنين، وضَمِن فوز المرشح الذي اختاره خامنئي. وكان ذلك آخر مسمار في نعش مؤسسة الانتخابات الإيرانية.
وكان المجتمع الإيراني، في المشهد الخلفي، لا يزال يناضل من أجل حقوقه الأساسية. في عام 2017، اعتلت الناشطة فيدا موحد، البالغة من العمر 32 سنة، صندوق توزيع كهربائي في شارع “انقلاب” بطهران وخلعت غطاء رأسها الأبيض، ولوّحت به بصمت. فوُضعت خلف القضبان، ولكن آلاف النساء حذونَ حذوها، ونشرن صورهنّ على وسائل التواصل الاجتماعي في ما صار يُعرف باحتجاجات “بنات شارع انقلاب”. وفي عام 2019، احتج الإيرانيون على ارتفاع أسعار الوقود بين عشية وضحاها. وبحسب منظمة العفو الدولية، قتل النظام أكثر من 300 متظاهر في ثلاثة أيام؛ وبعض التقديرات تُحصي عدداً أعلى من ذلك بكثير. وصدم الأسلوب الوحشي الإيرانيين، وعوض إرهاب الناس، وإجبارهم على الخضوع، أدى رد الدولة إلى إثارة مزيد من الغضب.
وبعدها حدثت خضّة معنوية: في 8 يناير (كانون الثاني) 2020، أسقط الحرس الثوري طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 176 راكباً، ومعظمهم إيرانيون. وفي البداية ألقت الحكومة باللوم في تحطم الطائرة على مشكلة فنية فيها. وترتّب على هذه الكذبة مزيد من الأكاذيب. وبعد ثلاثة أيام وتدقيق دولي مكثف، انتقل الحرس الثوري الإيراني إلى إلقاء اللوم على “خطأ بشري”، وأعلنوا أنهم حسبوا، عن طريق الخطأ، أن الطائرة كانت صاروخ كروز أميركياً يستهدف مكتب المرشد الأعلى، رداً على هجوم إيران بالصواريخ الباليستية على القواعد الأميركية في العراق، وهذا كان، في حد ذاته، عملاً انتقامياً من قتل الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد قبل أيام قليلة. وأدت هذه الحادثة، ومحاولة التستُّر عليها، إلى تفاقم انعدام ثقة المجتمع في الدولة على نحو لا يمكن إصلاحه. وإلى يومنا هذا، فشل النظام في تقديم المسؤولين إلى العدالة. ثم اندلعت الاحتجاجات مرة أخرى، ومرة أخرى، قمعها النظام.
وهذا الصنف من الانتصارات لا يصنع منتصراً. ومع تدمير شرعية إيران الانتخابية، تراجعت ثقة الجمهور في المؤسسات الإيرانية، وتعاظم الاستنكار المعنوي. وعلى رغم ذلك، مضت الجمهورية الإسلامية على تقويض نفسها. وزعمت فائزة هاشمي رفسنجاني، ابنة أحد الآباء المؤسسين والأساسيين للنظام، أن القمع الذي مارسه الشاه يبدو ضئيلاً بالمقارنة مع ما ارتكبته الجمهورية الإسلامية إلى اليوم. (قُبض عليها في سبتمبر). والنظام الذي مجّد دفاعه عن البلاد ضد “حرب مفروضة”، عندما غزا الرئيس العراقي السابق صدام حسين إيران في عمل عدواني، ادّعى أن حلف الناتو كان سيهاجم روسيا، في آخر الأمر، لو لم تستبق روسيا الرئيس فلاديمير بوتين الأمور، وتهاجم أوكرانيا، متفوقاً بتلك الحجة على بوتين نفسه. والبلد الذي كان ضحية الأسلحة الكيماوية العراقية أشاح بنظره بعيداً عندما فعل حليفه السوري الشيء نفسه في شعبه. والآن، يبدو أنّ توصيف الجمهورية الإسلامية للأعداء الإقليميين على أنهم “أنظمة قاتلة للأطفال” هو مجرد كلام فارغ نظراً لعدد الأطفال الذين سقطوا ضحايا بطش إيران.
وجرّاء رفضها العنيد الاستماع إلى شعبها، وتصديقها البروباغندا التي نشرتها، وحظرها، غير الاحتجاج، أي وسيلة للتغيير، انتهت الجمهورية الإسلامية إلى مرحلة الاضطرابات الاجتماعية. ولكنها تكبت كل قرينة على الانقسام بين كبار القادة. فالنظام لم يشهد انشقاقات كبيرة.
وخلافاً لحكومة الشاه، لا تملك النخبة في الجمهورية الإسلامية فيلات في كوت دازور، أو جبال الألب السويسرية، أو جنوب كاليفورنيا، يمكنهم الفرار إليها. وليس ثمة من يعدهم بمخرج، أو عفو، في حقبة ما بعد الجمهورية الإسلامية. لذا، لا يُحرج النظام الادعاء بأن الاحتجاجات هي مؤامرة ضخمة مدبرة من الخارج، بدلاً من النظر إلى مرآة يرى فيها صورته الحقيقية.
انضمّوا إلينا في نضالنا؟
ومن ناحية أخرى، هناك شعب إيران. ويمكن تقسيمه إلى أربع جماعات مختلفة. في الطليعة هناك الثوار. معظمهم في سن المراهقة وأوائل العقد الثالث من العمر، ويمثّلون جيلاً متهوّراً تخلّى عن حذره تماماً ورمى أغطية الرأس في النار. وعلى رغم أنهم يبدون أقلية، إلا أنهم، بحسب ما تبيّن، غير مستعدين للرضوخ. إنهم لا يتجنبون المخاطرة، مثل أبناء جيلي الذين تذكّر آباؤهم الثورة، وأدركوا أن التغيير الجذري غالباً ما ينتهي بالتعاسة. فهم يبدون عازمين على البراءة من فشل آبائهم وأجدادهم في مواجهة النظام الذي حرمهم مستقبلهم.
وأبناء هذا الجيل، الذي ولد في بلاء اليأس، يسعون الآن في استعادة عالمهم من المتعصبين، أعدائهم. ويتجسد هذا الشعور في شعار المتظاهرين: “عدونا هنا، هم يكذبون عندما يقولون إن العدو هو الولايات المتحدة”. وقد أظهروا درجة ملحوظة من الإبداع في احتجاجاتهم، وأنشأوا حركة بلا قيادة، عفوية، وغير محددة المعالم، ومجزّأة، ما جعل سحقها عن يد قوات النظام أشبه بلعبة “واك-إي-مول” Whac-a-Mole [أي أنه من الصعب محاولة إيقاف هذه التحركات المتكررة والعشوائية التي لا يمكن توقعها، فما أن تقضي عليها في مكان ما حتى تظهر في مكان آخر].
في الجماعة الثانية أشخاص يتعاطفون مع الثوار الشباب لكنهم لم يتحركوا بعد. وهي تتألف، في الغالب، من الطبقة الوسطى التي يطغى عليها، على نحو مطّرد، أشخاص في منتصف عمرهم، وبناء عليه، تتحفّظ هذه الجماعة تحفُّظاً عميقاً عن المطالبة بالتغيير الجذري في غياب بديل قابل للتطبيق. وهي قلقة من العواقب المحتملة والمترتبة على محاربة النظام في الشارع، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه لم يبقَ لها ما يسندها بعد سنوات من العقوبات وسوء الإدارة، ولا يمكنها بالتالي تحمُّل مواجهة طويلة ومكلفة مع الدولة. وهذا الجيل، في معظمه، على حد تعبير الروائي الفرنسي فيكتور هوغو، “لا يرغب في شيء سوى الراحة، ولا يتعطش إلا لشيء واحد هو السلام… لقد رأينا ما يكفي… من الأحداث العظيمة، والمخاطر الهائلة، والمغامرات الكبرى، والرجال العظماء…”.
وهذه الجماعة خلقت معضلة حسابية للحركة، فلم تُبلغ الاحتجاجات الحجم المطلوب، ولم تُطوّر رؤية إيجابية إلى المستقبل، ومن غير المرجّح أن تنضم الغالبية الصامتة إليها. ولن يكون بلوغ هذه الكتلة حجماً ممكناً من دون مشاركة أفراد هذه الجماعة. وفي المستقبل القريب، قد يسهم محفّز آخر في تغيير الحسابات، ويُخرج هذا الجيل إلى الشوارع. لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد.
والجماعة الثالثة تضم عناصر النظام الذين لديهم مصلحة أيديولوجية أو مالية تعود عليهم من الوضع الراهن. وعلى رغم أن هؤلاء المؤمنين الحقيقيين والمستفيدين قد تقلصوا إلى أقلية مطلقة، فهم، خلافاً لمناصري النظام الملكي الذين لم يكونوا مستعدين للخروج إلى الشوارع من أجل محاربة “اليعاقبة الإسلاميين” في عامي 1978 و1979، مستعدون للجوء إلى العنف دفاعاً عن أسلوب حياتهم، وعن النظام الذي يجسد هذا الأسلوب. وهذا يزيد خطر الاقتتال الداخلي بين طبقات المجتمع المختلفة.
وأخيراً، هناك المغتربون الإيرانيون. وفي العقود الأربعة الماضية، اجتمع هؤلاء، في أشكال لم نشهدها، على دعم المواطنين داخل وطنهم المعذب. وهم سلّطوا ضوءاً ساطعاً على الفظائع التي ارتُكبت في حق الشعب الإيراني وحصلوا على دعم دولي في خدمة قضية المحتجين. ويرى بعض أصحاب أعلى الأصوات بينهم، أن هذه معركة تهدف إلى إسقاط النظام، بالغاً ما بلغت التكلفة. وفي بيئة عنيفة، يناهض هؤلاء أي شخص يتجرأ على تبني وجهات نظر تختلف قليلاً عن وجهات نظرهم في الطريقة المناسبة لانتقال إيران إلى الديمقراطية، وتحتوي، في الوقت نفسه، تهديدات تتهدّد بها الجمهورية الإسلامية السلم والأمن الدوليين. وأدى فشلهم في تكوين صورة إيران التي يريدونها، وتبنّي نهج سياسة الخيمة الكبيرة [التي تشجّع تنوّع الأفكار وتعدد الآراء] في الحرب على الجمهورية الإسلامية، إلى تفرُّق المعارضة الإيرانية وتشرذمها.
فهذه الحركة التي يجلو شعارها الأساسي صورة فريدة عن التعددية والتقدمية (“النساء! الحياة! الحرية!”)، يستغلّها بعض المغتربين، ويشنّون حملة انتقامية على مغتربين آخرين يتهمونهم، مفتئتين، بأنهم متعاونون مع النظام. ويتصيّد المراقبون الإلكترونيون المتعصّبون النقادَ، وصانعي السياسة بشكل تعسّفي، بينما ينقلب المغتربون بعضهم على بعض، ويصفّون الحسابات، ويدافعون عمّن سيرث الخلافة.
وأنا أدرك أنهم قد يشهّرون فيّ، ويتطاولون عليّ بسبب هذا المقال، لكن تشدُّد هذه الجماعة، وميلها إلى استخدام الوسائل غير الديمقراطية، يحاكيان الاستبداد الذي ابتُليت به إيران منذ مدة طويلة. وقد يستمر، بمساعدة ثقافة الاستبداد هذه، إلى ما بعد الجمهورية الإسلامية.
ومن غير الواضح حجم الدعم داخل البلد، للأهداف التي يسعى المغتربون فيها. وعلى سبيل المثال، لا يبدو أن المتظاهرين الإيرانيين يطالبون الدول الغربية بوقف المحادثات النووية مع إيران، أو بطرد الدبلوماسيين الإيرانيين. وفي المقابل، لا يبدو أن لمطالبة المحتجين بإجراء استفتاء في النظام السياسي الإيراني تلقى صدىً كبيراً في الخارج.
ويريد عدد من الإيرانيين المنفيين من الولايات المتحدة أن تفعل هذه المزيد من أجل الإيرانيين، فتُكرر ما فعله الغرب في أوائل تسعينيات القرن الماضي من أجل المساعدة على ولادة الديمقراطية في جنوب أفريقيا. وهم لا يحتسبون أن نظام الفصل العنصري اتكأ على الغرب ولم يناصبه التحدّي، ولا أن إيران اليوم لم تحظَ بنيلسون مانديلا أو فريدريك ويليم دي كليرك وهو على قدر أهمية مانديلا. ويعتبرون أن التغيير الثوري في إيران عام 1979، وتونس عام 2011، ومصر عام 2011، لم ينتج من العقوبات الأميركية أو العزلة المفروضة. وفي المقابل، لم تُنتج رغبة واشنطن المعلنة في التخلص من قادة سوريا عام 2011، وفنزويلا عام 2019، أي نتيجة. ويصحّ القول إن محاولة الولايات المتحدة إنشاء نظام جديد في العراق أدت إلى كارثة رهيبة.
والحقيقة المثيرة للقلق هي أن قضية تحرُّر الشعب الإيراني تصمد أو تسقط من تلقاء نفسها. والأجانب هم، في الغالب، متفرجون. وهذا لا يعني أنه لا شيء في وسع الولايات المتحدة المساعدة عليه. وقد اتخذت إدارة بايدن إجراءات مهمة، وعبّرت باستمرار عن تضامنها مع المتظاهرين الإيرانيين، على أعلى المستويات. وسلّطت الضوء على محنتهم في المحافل الدولية، وعزلت إيران على المسرح الدولي. واستخدمت واشنطن العقوبات في معاقبة النظام، ومساعدة الإيرانيين العاديين، وشدّدت القيود على منتهكي حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه خفّفت عن الشعب الإيراني القيود على الوصول إلى المعلومات، بينما سعت الحكومات في عزله عنها. وحاولت تحقيق توازن دقيق. فلم تقف على حدة، على خلاف إدارة أوباما في عام 2009، لكنها لم تضطلع بدور طرف في المعركة، على خلاف إدارة ترمب في عام 2019، على رغم سعيها من طرف خفيّ في تغيير النظام.
وثمة اعتبارات أميركية أخرى في إيران. فلا يمكنها أن تتجاهل برنامج طهران النووي الذي اقترب، أكثر من أي وقت مضى، من صنع سلاح نووي، ولا مصير المواطنين الأميركيين الثلاثة المحتجزين. على رغم ذلك، إذا تعاملت واشنطن مع الأوصياء على الجمهورية الإسلامية، فسوف يوجّه النقاد، في الداخل والخارج، اللوم إلى الولايات المتحدة لأنها أنقذت نظاماً على شفير الانهيار. وفي الوقت نفسه، قد يحمل عدم الانخراط في الدبلوماسية إيران إلى اجتياز نقطة اللاعودة، وتطوير سلاح نوويّ كرادع نهائي ضد تهديد النظام. وهذا لا يخدم لا السلام العالمي، ولا قضية الديمقراطية في إيران. وقد يؤدي التدخل العسكري الأميركي أو الإسرائيلي، إلى شحذ تصميم النظام على حيازتها، وزيادة أمن وعسكرة الساحة الداخلية الإيرانية، وزعزعة استقرار المنطقة فيما تحاول حكومة مصابة أن توجّه رداً انتقامياً، على أمل أن تبعث تأثير “الالتفاف حول العلم” [إظهار التأييد الشعبي في أوقات الأزمات]، فتعوّض خسارة المشروعية التي جرّتها على نفسها، وذلك عوضاً عن لجم اندفاع إيران إلى صناعة السلاح الذرّي. ومن الصعب أن نرى كيف يسهم وصول الأزمة النووية إلى ذروتها في تحويل إيران دولةً ديمقراطية.
غموض مؤكد
وتوقُّع ما سيحدث بعد ذلك هو مسعى عقيم. والنظام بذل كل وسعه في سبيل وقف التظاهرات، وانتظر آملاً في أن تتلاشى الحركة. وشنَّ حملات قمع عنيفة لمنع التجمعات الجماهيرية. وحاول استدراج المناطق النائية، حيث تقيم بشكل خاص الأقليات التي تتعرض لسوء المعاملة في إيران، إلى التطرُّف في سبيل تعميق المخاوف من اندلاع حرب أهلية. وحاول تفريق الحركة، والتغلب عليها من طريق محاورة بعض الشخصيات الإصلاحية، وتأجيج الاقتتال في صفوف المعارضة في المنفى. وهو أعدم المتظاهرين، أو بحسب وصف الأمم المتحدة، شارك في “قتلهم بموافقة الدولة” من أجل بث الخوف. بيد أنّ كل هذه الجهود، في أحسن الأحوال، تُكسب النظام مزيداً من الوقت إلى أن تحين المواجهة الحتمية التالية بين الدولة والمجتمع.
والشعب الإيراني، في الـ 44 عاماً الماضية، طرأ عليه تغيير كبير، ولكن الجمهورية الإسلامية لم تواكب هذا التغيير. وهي غير قادرة على الاعتراف بأخطائها، وتصحيح نفسها، لأنها تخشى أن يؤدي التنازل تحت الضغط إلى مزيد من الضغط، من أسفل الهرم إلى أعلاه، ومن الخارج. وتعترف المعارضة في المنفى، من ناحيتها، بأن الصراع ضد النظام من المرجح أن يكون سباق مسافات طويلة، وليس عدْواً سريعاً.
وتسعى هذه المعارضة في إنجاز حملة ضغط قصوى وعزل نهائي، على أمل تسريع زوال النظام. ويبدو أن ما ستفعله كل هذه الضغوط على الشعب الإيراني بنسيج المجتمع أمر ثانوي في نظر كلا الجانبين، بغضّ النظر عما إذا كانت ضغوطاً من فوق، أي من قبل النظام، أو من الخارج. وليس ثمة مخارج واضحة لعلاقات إيران المتردّية مع الغرب، إذ يواصل الجانبان التصعيد: إيران من خلال توسيع برنامجها النووي ومساعدة روسيا في حربها العدوانية ضد أوكرانيا، والغرب من خلال تشديد العقوبات.
وأخشى أن حلمي برؤية إيران أكثر تعددية وازدهاراً وحرية يتلاشى مع كل جثة جديدة متدلية من حبل على المشنقة، ومع كل عقوبة جديدة، وتعاظم سياسات الكراهية. وآمل، على رغم كل الصعوبات، في ألا تنتهي هذه المرحلة نهاية فظيعة، وألا تفضي إلى أهوال أبدية. ولكنّني على ثقة من أمر واحد: هو أنه لن يظل شيء على حاله.
* علي فائز هو مدير برنامج إيران في “مجموعة الأزمات الدولية” وأستاذ مساعد في كلية إدموند أيه. وولش للشؤون الدولية في جامعة جورج تاون.
اندبندنت عربية