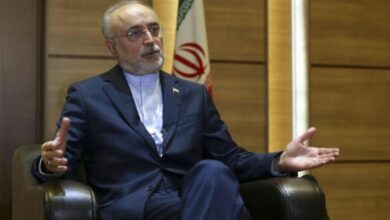رعاة إيران الجدد
رويل مارك غيريشت
عند توليهم السلطة سنة 1979 تفاخر ثوريو إيران برفضهم النظام العالمي. وأعلن آنذاك آية الله روح الله الخميني، المرشد الأعلى الأول للبلاد، أن دولته لن تكون “شرقية ولا غربية”. واعتبر الخميني أن الولايات المتحدة هي “الشيطان الأكبر”، القوة الإمبريالية الأبرز والمفسدة للروح، وسند طغاة تغريبيين حكموا العالم الإسلامي. ولم يكن الاتحاد السوفياتي والشيوعية الملحدة، وفق الخميني، أقل شؤماً وأذى. فقال في هذا الموضوع، سنة 1980: “أصدقائي الأعزاء، عليكم أن تدركوا أن الخطر الآتي من القوى الشيوعية لا يقل عن الخطر الآتي من أميركا”.
وبرفضها الشركاء، جاهرت الجمهورية الإسلامية (الإيرانية) أنها لن تكون بلداً عادياً، يسعى في تحصيل الحد الأقصى الممكن من المنافع بواسطة عقد التحالفات. وعوضاً عن ذلك، اعتبر النظام الثوري نفسه نظاماً طليعياً، مهمته قيادة شعوب العالم المستضعفة نحو الحرية والعدالة. وبعد صد الجنود الإيرانيين الجيش العراقي عن الأراضي الإيرانية، سنة 1982، تحولت حرب الجمهورية الإسلامية ضد العراق إلى حركة تحررية رمت إلى تحرير المسلمين في المنطقة بأسرها، وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط.
وتآمرت الحكومة الإيرانية على إسقاط حكومات بلدان مجاورة، ورعت منظمات إسلاموية إرهابية كثيرة في الشرق الأوسط. وتعاطفت قيادة رجال الدين (في إيران)، فعلاً، مع متطرفي اليسار العلماني المعادي لأميركا أينما حاذتهم، ولكن سرعان ما أدركت طهران أن المضي على وحدتها ليس استراتيجية فعالة.
وأدت حماسة إيران الثورية، وسعيها في تصدير الثورة، إلى ذر الخلاف مع معظم دول العالم، ومع الدول المحيطة بها والقريبة منها خصوصاً. وأسهم موقف الجمهورية الإسلامية الثوري والمعاند في أثناء الحرب العراقية – الإيرانية في شحذ المشاعر الطائفية، وتعاظمها في منطقة الشرق الأوسط. ولا شك في أن إيران باعت نفطها، ولكنها لم تغد أبداً وجهة للتجارة العالمية. وحين توفي الخميني، سنة 1989، لم يكن بلغ أياً من أهدافه الخارجية.
واضطر خلفاء الخميني إلى النظر من جديد في تقويم نظامهم الثوري. وحين تولى منصبه، مرشداً أعلى جديداً للبلاد، عاد علي خامنئي، موقتاً إلى مد الجسور مع الخارج. وأبقت طهران على عدائيتها تجاه الولايات المتحدة، وظلت هذه الهدف الأول لسخطها، لكنها قلصت التزامها تصدير ثورتها إلى البلدان الإسلامية. واطرحت بعضاً من وقت كانت صرفته إلى التحريض على دول خارج النطاق الغربي. وشرعت في البحث عن رعاة جدد بين القوى العظمى. وهي عانت الأمرين، في البداية، للعثور عليهم، لأنها سعت في بحثها في وقت غير مواتٍ، أي بعد الحرب الباردة مباشرة، بينما كانت القوة الأميركية من دون منافس تقريباً.
وكان الأوروبيون، من جهتهم، على الدوام مستعدين للتعامل مع إيران، ولكن استثماراتهم، حتى في قطاع النفط، ترددت في الإقدام على دخول السوق الإيرانية. وكانت الصين وروسيا أشد حرصاً وحماسة على عقد علاقات تجارية مع إيران. ولكنهما لم تكونا، يومذاك، تشاركتا مع طهران في عدائها لواشنطن. والحق أن بكين وموسكو كانتا تخشيان معاداة الولايات المتحدة وهي في عز قوتها بعد الحرب الباردة.
وتبدل الأمر في أثناء الـ15 سنة المنقضية. فتقلص نفوذ واشنطن، وتراجعت قوتها. ورأت بكين وموسكو أن في مقدورهما تحدي النظام الليبرالي الدولي السائد. واستقبلتا المسؤولين الإيرانيين دورياً، ومنحتا طهران مزيداً من دعم اقتصادي وعسكري قوي، واستفادت طهران كثيراً من هذا الدعم، على رغم اقترانه بشروط. فوفرت الصين لإيران خطوطاً تجارية خارج العقوبات الأميركية، وسبيلاً أسهل للحصول على التكنولوجيا المتطورة. فلم يخش نظام الملالي، بعدها، الانهيار الاقتصادي.
وتولت روسيا، من جهتها، تحديث الجيش الإيراني. وأنشأت بكين وموسكو وطهران، محوراً دبلوماسياً على حدة، أسهم ويسهم في إنهاء عزلة الجمهورية الإسلامية على نحو ملموس. وبات في إمكان نظام الملالي الإيراني الذي يسانده هذان الحليفان، المضي قدماً في صناعة قنبلة ذرية، في وقت يراه ملائماً. وبفضل دعم روسيا والصين، تشعر حكومة طهران، اليوم، بأنها أكثر قوة وأماناً من أي وقت مضى.
ذئب مستوحد
بداية، في التسعينيات، عندما حاولت إيران الانفتاح في ولاية أكبر هاشمي رفسنجاني، فواجهت البلاد صعوبات كثيرة. وكان من الصعب على من افترض أنهم تكنوقراط ثوريون، خلف قيادة الملالي، بناء اقتصاد أكثر تماسكاً وذا بنية تحتية حديثة. وهم لم يستملهم حكم القانون، ولا السياسات الضريبية الموحدة، ولا عمليات التدقيق النزيهة – وهي الأمور الثلاثة التي تشكل شروطاً أساسية للتطور الاقتصادي المستدام. وهؤلاء (التكنوقراط الثوريون) لم يغيروا في نظام الجمهورية الإسلامية الغنائمي [قوامه تقاسم الغنائم]، وتشكل فيه شبكات العائلات والملالي والحرس الثوري، قوى اقتصادية وازنة. فبقي الفساد، وهو يفرض أحياناً بوسائل عنيفة واستشرى.
وكانت إيران تمكنت من انتهاز بعض الفرص في الخارج قبل حلول الألفية الراهنة. فالصين، تلبية لحاجاتها المتزايدة للطاقة، راحت تشتري كميات كبيرة من النفط الإيراني. وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي، سنة 1991، مرت روسيا بضائقة اقتصادية شديدة، فقامت بتطوير علاقة تجارية مربحة، تمثلت ببيع أسلحة إلى طهران.
وفي المقابل، تجاهلت الجمهورية الإسلامية المذبحة التي ارتكبتها روسيا في حق المتمردين المسلمين في الشيشان. ولما أدركت (إيران) قلة جاذبيتها في المناطق الإسلامية السنية التي تتكلم اللغة الفارسية في وسط آسيا، وبسبب رغبتها في عدم إغضاب موسكو، لم تقم طهران بتنشيط حضورها الديني في الدول المجاورة لروسيا.
لكن كلا من الصين وروسيا لم تكن تنوي يومها إقامة شراكة جدية مع الجمهورية الإسلامية. فالصين صرفت جهدها كله إلى تطوير اقتصادها الوطني، وكانت في حاجة إلى دخول سوق الولايات المتحدة والحصول على التكنولوجيا الأميركية. ولم يكن لبكين مصلحة في عقد تحالف مع أحد خصوم واشنطن الأساسيين. وحرص الرئيس الروسي بوريس يلتسين، ثم خالفه فلاديمير بوتين، على التحاور والتجارة مع الولايات المتحدة، وذلك في سياق سعيهما في دمج روسيا في الاقتصاد العالمي. أما خامنئي، فرغبته الراسخة في إقامة حلف أوراسي (أوروبي – آسيوي) ضد واشنطن، لم تتحقق.
بدأت إيران بالسعي لشركاء في لحظة غير مواتية
سرع رفسنجاني وخامنئي، المعزولان في مطلع التسعينيات، وتيرة الأبحاث النووية السرية في البلاد، وكانت بدأت في الثمانينيات في أثناء الحرب العراقية – الإيرانية. وبارك الرجلان تجارة الأسلحة المحظورة مع كوريا الشمالية (في مذكراته المنشورة سنة 2014، تباهى رفسنجاني بهرب السفن الإيرانية، التي تحمل “مواد حساسة” من كوريا الشمالية في 1992، من مراقبة البحرية الأميركية).
وفي سنة 2002، عندما قامت مجموعة من المنشقين بكشف حقيقة امتلاك الجمهورية الإسلامية برنامجاً نووياً متطوراً نسبياً، رد الأوروبيون بالدبلوماسية، فيما فرض مجلس الأمن في الأمم المتحدة عقوبات على الملالي. أما الولايات المتحدة، المنهمكة آنذاك بالحرب في أفغانستان وبالإعداد لاجتياح العراق لاحقاً – وهو الغزو الذي برر جزئياً بالخشية من سعي صدام حسين إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل – فشاركت مع الأوروبيين في المسار الدبلوماسي.
ووصف حسن روحاني، رئيس الوفد الإيراني الذي فاوض أوروبا على الملف النووي من 2003 إلى 2005، ورئيس البلاد لاحقاً، هذه السنوات في الوقت الصعب على نحو استثنائي. ففي مذكراته المنشورة سنة 2012 أكد روحاني أن “أحداً لم يتوقع انهيار نظام صدام (حسين) في ثلاثة أسابيع”.
وتابع “قادتنا العسكريون أبلغونا أن صدام لن يهزم سريعاً وتحتاج أميركا إلى ستة أشهر على أقل تقدير، أو سنة، للوصول إلى قصره”. وفي خطاب ألقاه سنة 2005 أمام “مجلس تشخيص مصلحة النظام” وأعضاء مجلس الأمن الوطني، وصف روحاني الرئيس جورج دبليو بوش بـ”الحبشي المخمور” – هذا الوصف بالفارسية يعني “راعي البقر المجنون”. والولايات المتحدة، وفق رأي النظام (الإيراني)، عملاق غاضب. وبات الآن مطارداً في الشرق الأوسط.
وردت إيران بحذر (على الغزو الأميركي)، ولم تواجه واشنطن في العراق. وفرضت الولايات المتحدة رزمة من العقوبات على الجمهورية الإسلامية، تضافر أثرها مع أثر اقتصاد اشتراكي يتسبب في إفقار الإيرانيين، وأدت العقوبات، على نحو حاد، إلى تقليص قدرة إيران على جذب الاستثمارات الأجنبية، والتجارة، والعملة الصعبة. وكانت الأزمة النووية الناشئة، يومها، انعطافاً. فرأى الإيرانيون أن بلادهم تحتاج إلى الدعم الصيني والروسي في سبيل تقليص الضغط الأميركي والحصار على بلدهم.
لكن، في البداية، لم تقدم أي من هاتين القوتين العظميين دعماً لإيران. ففي سنة 2003، عندما زار روحاني بكين وموسكو طالباً المساعدة، لم يحصل على مبتغاه. فقال له وزير الخارجية الصيني لي زهاوجينغ، في معرض الكلام عن واشنطن وحلفائها، “لا تتوقع أن نقف ضدهم”. أما في موسكو فكان بوتين أكثر صراحة فقال، خلال اجتماع مع روحاني، “لن نقف في مواجهة العالم من أجلكم. نحن جيران، لكننا لن نعرض مصالحنا القومية للخطر”. وكانت واشنطن، خلال ولاية بوش الثانية والولاية الأولى لباراك أوباما، استخدمت نفوذها لإقناع الصين بتقليص مشترياتها من النفط الإيراني، ولإقناع روسيا بتقييد مبيعات أسلحتها لطهران.
أخوة الدم
وطوال العقدين الأولين من الألفية الثالثة استمرت إيران في معاناتها وحيدة، ولكن ما إن أطل العقد الثاني حتى بدأت الحوادث العالمية تميل لمصلحتها. فالتمرد المسلح في العراق، الممول والمخطط له جزئياً في طهران، استنزف العزيمة الأميركية في الشرق الأوسط. وساعد توسع مناهضة الحرب أوباما على الفوز بالرئاسة في الولايات المتحدة. وفي سياق سعي باراك إلى بداية علاقة جديدة بالعالم الإسلامي، واقتناعه بإمكان تذليل الخلافات المزمنة مع إيران من طريق تدخله الشخصي، افتتح دبلوماسيته مع خامنئي بقبول المكاسب النووية الإيرانية الرئيسة.
فالاتفاق النووي الأخير سنة 2015، المعروف بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة”، لم يعط فقط ضوءاً أخضر لعمليات تخصيب اليورانيوم المحلية في الجمهورية الإسلامية، بل أقر للنظام (الإيراني)، بعد 15 عاماً، بحرية التخصيب بمعدلات صناعية، بينما كان الاقتصاد الإيراني يعاني من ضائقة شديدة، جاء الاتفاق النووي ليملأ الخزانة الإيرانية بالمال، ويشرعن مطامح إيران النووية.
وعلى هدي المنطق الخاطئ الذي قاد إلى استثمارات غربية ضخمة في الصين الشيوعية وروسيا ما بعد الاتحاد السوفياتي، افترض الاتفاق النووي (في عهد أوباما) أن فتح أبواب التجارة الحرة مع إيران قمين بتحويلها دولة أقل تهديداً ويسكن تعبئتها الأيديولوجية.
ولم تكن السياسات الأميركية العامل الوحيد الذي شجع طهران وفسح المجال لها. فبعد التحرك الشعبي الإيراني الكبير المناصر للديمقراطية، المعروف بـ”الثورة الخضراء”، جاء الربيع العربي، سنة 2011، وأسقط حكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنح نظام الملالي فرصة لمصلحته. فعلى رغم أن معظم الدول لا تود أن تكون في وسط منطقة محاطة بالاضطرابات، استطاعت إيران الاستفادة من الفوضى في المنطقة، واستثمرت في حال عدم الاستقرار الناتجة من الربيع العربي لتوسيع نطاق نفوذها.
وكان نظام الملالي منذ زمن بعيد يعتمد على الجماعات الشيعية الأقلية المقموعة والمتطرفة، وعلى الميليشيات الشيعية والسنية على حد سواء، لأجل بسط نفوذه. وغدا نظام الملالي، عبر أولئك الوكلاء، “صانع الملوك” في المشهد السياسي العراقي المنقسم، إذ لا يمكن لأي رئيس وزراء عراقي تولي هذا المنصب، كما لا يمكن للبرلمان العراقي أن ينعقد، إلا بموافقة طهران ورضاها. وأرسلت إيران “الحرس الثوري” إلى سوريا، جنباً إلى جنب قوات ميليشياوية أخرى قوامها نحو 70 ألف رجل للمساعدة في سحق التمرد السني ضد الرئيس السوري بشار الأسد في سياق الربيع العربي. فدان نظام دمشق، وهو كان من قبل يميل إلى طهران، ببقائه لإيران.
وفي لبنان، جار سوريا، سيطر “حزب الله”، الميليشيات المسلحة التي أنشأتها إيران، على الحكومة. وفي اليمن، نجح الحوثيون الشيعة، وإيران من ورائهم، في إلحاق الهزيمة بالقوات المعادية في الحرب الأهلية الأخيرة في ذاك البلد.
عملت الصين على تخفيف وامتصاص معظم آثار العقوبات الأميركية المفروضة على إيران
هذه الانتصارات الإقليمية لم تخفف معاناة إيران الاقتصادية، إلا أن الخلاص الاقتصادي وتجاوز الأزمة قد يكونان قريبين. ففي أثناء السنوات القليلة الماضية أنشأت الصين منطقة نفوذها الخاصة. وسعت بكين، على نحو خاص، في اكتساب امتيازات خاصة تيسر لها الوصول إلى المصادر في دول جنوب العالم، وجعلت من إيران، صاحبة التأثير الكبير في الشرق الأوسط، جزءاً مهماً من برنامج بسط نفوذها.
وفي سنة 2021، وقعت الصين والجمهورية الإسلامية اتفاق لـ25 سنة تمكن الصينين من الدخول إلى كافة القطاعات الاقتصادية الإيرانية تقريباً. وتخطط الصين للاستثمار في قطاعي البنى التحتية والاتصالات الإيرانيين، وهي وعدت بالمساعدة على تطوير قطاعي الطاقة والصناعة النووية المدنية (كما يفترض) في الجمهورية الإسلامية.
وهذه الاتفاقات مكسب اقتصادي وأمني حازه نظام الملالي. فإيران تبيع في كل شهر ملايين براميل النفط للصين. ودخلها القومي يتنامى، بعد أن تقلص إلى نصف متوسطه بين عامي 2017 و2020. وفي فبراير (شباط) 2023، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن بكين “تدعم إيران في حماية سيادتها الوطنية”، وتساند جهودها في “مقاومة الأحادية والابتزاز” (في السياسة الدولية، والمقصود طبعاً السياسة الأميركية).
والجمهورية الإسلامية هي عضو في “منظمة شانغهاي للتعاون”، وفي شهر أغسطس (آب) دعيت إيران للانضمام إلى مجموعة “بريكس” التي تتألف من دول اقتصادات نامية كبيرة. وكانت إدارات أميركية عدة ومتعاقبة أملت في أن تؤدي الضغوط المالية والدبلوماسية إلى إجبار نظام الملالي على التنازل عن أصوله وموجوداته النووية، غير أن إجراءات الصين جعلت هذا السيناريو متعذراً. فهي عملت على امتصاص معظم آثار العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وأضعفتها. وتقوم روسيا كذلك بمساعدة طهران. وفي الأشهر العشرة الأولى من سنة 2022، ارتفعت الصادرات الروسية إلى إيران 27 في المئة.
ووقع البلدان مذكرة تفاهم تلزم موسكو باستثمار 40 مليار دولار في مشاريع الغاز الإيرانية. ومن السهل أن نفهم اليوم سبب قيام روسيا بمد يدها لإيران. فاجتياحها لأوكرانيا عزلها عن كثير من شركائها التقليديين، بينما وقفت إيران، من دون تردد، إلى جانب روسيا.
وفي هذا السياق، قال خامنئي، في مارس (آذار)، مؤيداً رأي بوتين في النزاع، إن “الولايات المتحدة هي التي بدأت الحرب في أوكرانيا بغية تمديد حلف الناتو نحو الشرق”. وباعت إيران، خلال الحرب المستمرة، كميات كبيرة من المسيرات إلى روسيا. ولقاء هذا، فتحت موسكو ترسانتها أمام طهران، فزودت إيران بمنظومات الدفاع الجوي، وطائرات الهليكوبتر، وستزودها قريباً بطائرات حربية متطورة، مثل السوخوي “سو – 35”.
ثمن الأعمال التجارية
وقد لا يكون الشركاء الأقوياء أمراً جيداً كله، فالانضواء تحت جناح قوى عظمى يفرض قيوداً والتزامات، وقد تضطر الجمهورية الإسلامية إلى القيام بتنازلات عسيرة وغير مرغوبة حتماً. فاتفاق إيران مع الصين يرجح كفة بكين على كفة الاقتصاد الإيراني، إلى حد يذكر باتفاقات الاستسلام التي فرضتها أوروبا فيما مضى على الإمبراطورية الفارسية. وهذه مفارقة. فنظام رجال الدين يحب الزعم أن ثورته استعادت استقلال إيران، إلا أن الملالي أنفسهم يمنحون قوة عظمى أجنبية جديدة مداخل إلى مجال سيادتهم. والصين تزاول سلطتها من غير إبطاء. فهي ترغب في استقرار في منطقة الخليح الغنية بالنفط، خصوصاً بعد استثماراتها الاقتصادية الواسعة في السعودية.
وعلى نحو يناقض السياسة الصينية، تود إيران عرقلة خطوط نقل النفط في الخليج سعياً في إلحاق الضرر بمنافسيها العرب. ففي سنة 2019 مثلاً، هاجمت طهران، بواسطة مسيرات وصواريخ كروز منشآت شركة “سعودي – أرامكو” لتكرير النفط، فتسببت بتقليص موقت لإنتاج النفط السعودي بمعدل النصف، ما رفع أسعار النفط العالمية 20 في المئة.
ويبدو أن الصين أجبرت إيران على تخفيف التوتر، ورعت تجديد العلاقات بين إيران والسعودية بواسطة اتفاق وقعت في مارس (آذار)، وجمعت البلدان الثلاثة (الصين وإيران والسعودية). وربما استمرت الجمهورية الإسلامية، بين الوقت والآخر، في مهاجمة ناقلات النفط، ومحاولة ترهيب السعودية والإمارات العربية المتحدة، ولكن المرجح، الآن، أن يتراجع مقدار الضرر الذي قد تلحقه (إيران) بجيرانها الخليجيين.
وليست تلك الضوابط السبب الوحيد الذي دعا طهران إلى تجديد علاقاتها بالرياض. فلطالما صنف حكام إيران السعودية في باب يخالف تأويلهم للإسلام “الثوري”. ويهاجم الملالي سياسة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الداخلية. وهم يتهمون الرياض بإثارة تظاهرات “امرأة، حياة، حرية” التي هزت إيران سنة 2022.
وبين أطراف اتفاق مارس (آذار) الثلاثة، من الواضح أن إيران هي أقل الرابحين. فالصين، في هذا السياق، استعرضت مهارتها الدبلوماسية ونصبت نفسها قوة وازنة في الشرق الأوسط، فيما مهدت السعودية الطريق إلى حل مشكلة اليمن. وقد تكون ضمنت ألا تقصف الجمهورية الإسلامية – وهي تملك ترسانة صواريخ ومسيرات ضخمة متنامية – التجهيزات العملاقة التي تندرج في “رؤية 2030” التنموية والتطويرية، وينهض عليها مستقبل السعودية. والمكسب الوحيد الملموس الذي حصلت عليه من الاتفاق فهو عرفان الصين وامتنانها.
الصين قد ترحب بإيران نووية.
وفرضت روسيا على إيران أعباءً ثقيلة. فالجمهورية الإسلامية قد لا تكن وداً لأوروبا، ولكنها لا تريد أن تحول هذه القارة إلى عدو لدود، شأن الولايات المتحدة، ولكن إيران بدعمها بوتين وتزويده بأسلحة فتاكة، ضلعت في حرب غير مباشرة ضد “الناتو”. فمسيراتها وذخائرها تقتل الأوكرانيين، وتصعب على أكثر الأوروبيين اعتذاراً لها وتمسكاً بها، مهمة تبرير التعامل مع النظام (الإيراني). ويستنزف دعم إيران لروسيا، في نهاية المطاف، مخزون الجمهورية الإسلامية العسكري في حرب ليس لها غير تأثير ضئيل في مصالحها. فأوكرانيا ليست جزءاً من جوار إيران. وليس ثمة أهداف ثورية إسلامية معرضة للخطر في أوروبا الشرقية.
وبالغاً ما بلغ الصداع الذي قد تعانيه الجمهورية الإسلامية جراء عرابيها ورعاتها، يبقى مقبولاً مقارنة بالضرر الذي تلحقه هذه الشراكات بالمصالح الغربية، وعلى الأخص فيما يتعلق بامتلاك إيران أسلحة نووية. وكان القادة الأميركيون والأوروبيون قبلوا الاستنتاج الذي يقضي بأنه بالغاً ما بلغت خلافاتهم مع الصين وروسيا، فإن كلا البلدين لا يرغب في حيازة إيران قنبلة نووية. وربما لم يعد هذا الأمر صحيحاً. فعلى خلاف الولايات المتحدة، جاورت روسيا، طوال عقود، دولاً في محيطها، تملك سلاحاً نووياً.
وقد يشعر بوتين بارتياح كبير إذا أضيفت دولة جديدة إلى تلك الباقة من الدول. وليس صعباً تصور مشاركة روسيا إيران التكنولوجيات والخبرات النووية. وتجاوز إيران العتبة النووية يهزأ من وعود لا تحصى قطعها الديمقراطيون والجمهوريون بأن لا تسمح واشنطن أبداً لإيران بالحصول على القنبلة، لذا يربح بوتين من مساعدة حليفه الفارسي على إذلال الولايات المتحدة، والحط من شأنها وموقعها في الشرق الأوسط. وفي الإطار نفسه، قد يرحب شي جينبينغ بإيران نووية. فالرئيس الصيني لا يبالي بالأعراف والمواثيق الدولية، ولا يضيق بانتشار نووي إضافي. فهو لم يعترض على اجتياح بوتين أوكرانيا، ولم يحترم سيادة الهند الإقليمية في منطقة الهمالايا، أو دعاوى دول جزر المحيط الهادئ التاريخية في بحر الصين الجنوبي. وقد يخلص، منطقياً، إلى أن القنبلة الإيرانية ربما سرعت خروج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط.
وفي ضوء إجماع الطبقة السياسية الأميركية على التنديد بـ”الحروب الأبدية”، قد يسوغ شبح إيران النووية المضي قدماً على تقليص الحضور الأميركي في المنطقة. وترى بكين، وهدفها تايوان على الدوام، أن العواقب الدولية لإيران نووية تعود عليها بمكاسب أكيدة. ولا شك في أن صنع إيران قنبلتها يرتب على علاقاتها بحليفيها الكبيرين تغييراً عميقاً. فهي ستغدو أكثر جرأة وإقداماً، بعد أن كانت شريكاً هامشياً. وهي قد تعاود ضرب بنى النفط التحتية في الخليج. ويمكنها مشاركة حلفائها من الميليشيات تكنولوجيا صاروخية أفضل وأحدث، ويصبح لأولئك الحلفاء قدرة إضافية على الاستقلالية والعدائية. وهذه الاحتمالات لم تؤد بعد إلى حمل الصين وروسيا على تجديد النظر في علاقاتهما بالملالي الإيرانيين.
صخب إيران الأميركي
عندما يتعلق الأمر بإيران، لا ينبغي للرئيس الأميركي جو بايدن أن يسعد بالموقف الحرج الذي يجد نفسه فيه. فهو تولى الرئاسة غافلاً عن تنامي الشراكات التي تعقدها الجمهورية الإسلامية، بينما أفضى المشهد الجيوسياسي الأوسع إلى طي مرحلة تقييد انتشار الأسلحة وتعاظم التسلح.
وكان بايدن تحدث، في أول ولايته، عن صياغة اتفاق “أطول عمراً وأقوى” مع طهران، وذلك قبل الذهاب إلى “محادثات غير مباشرة” وطائشة، وافق فيها المفاوضون الأميركيون على ألا يلتقوا وجهاً لوجه مع الإيرانيين. وحاول بايدن إغراء نظام الملالي على صورة تنازلات تجارية، وتجاهل مساءلات “الوكالة الدولية للطاقة النووية” المتعلقة بأنشطة النظام (الإيراني) غير القانونية. ويشبه هذا شبهاً قوياً ما فعله أوباما سنة 2015، في سبيل عقد الاتفاق الأولى. ومن غير المفترض أن يكون بايدن قد تفاجأ حين رد النظام الإيراني الرد نفسه الذي جبه به أوباما، أي بتوسيع عمل أجهزته النووية. فإيران زادت، في أثناء رئاسة بايدن، معدلات تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة، وهو المستوى الذي يقتضيه صنع سلاح نووي خام. وفي يناير (كانون الثاني)، كشفت “الوكالة الدولية للطاقة النووية” مستوى تخصيب تجاوز الـ80 في المئة.
وتشبه الأجواء السائدة في الجمهورية الإسلامية، اليوم، الأجواء التي كانت سائدة قبل سنة، وهي أجواء احتفاء بالانتصار. فجمهورية خامنئي تجاوزت العقوبات والانتفاضة الداخلية. وبمساعدة حليفيها، وقوتيهما العظميين، تماسكت اقتصادياً وبدأت في تجديد دفاعاتها. والقنبلة النووية في المتناول. وعندما يقرر المرشد الأعلى تجاوز تلك العتبة، لن يكون ثمة سبب وجيه للاعتقاد أن إسرائيل، أو الولايات المتحدة، عازمة على وقفه بالقوة. وحينها، يكون خامنئي حقق ما فشل الخميني في تحقيقه. ويكون ضمن بقاء الثورة في وجه عدوها الأساس، الولايات المتحدة، وحول الشرق الأوسط، بعد محاولات دامت 44 سنة، إلى منطقة تهيمن عليها إيران.
نقلا عن اندبندنت عربية