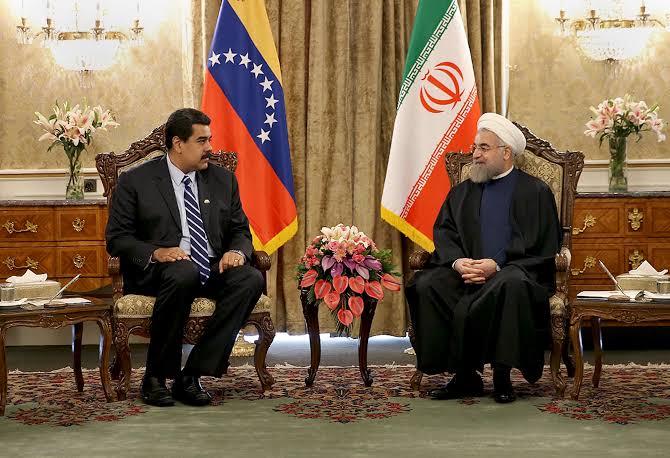التضليل لقتل الذكرى!
مصطفى علوش
«سيذكرني بعد الفراق أحبتي
ويبقى من المرء الأحاديث والذكر
ورود الربى بعد الربيع بعيدة
ويدنيك منها قوارير العطر» (بدوي الجبل)
لا داعي لانتظار الرابع عشر من شباط في كل عام، منذ 18 عاماً، لكي أستذكر رفيق الحريري. فعلى الرغم من محاولات تشويه وتعتيم السيرة، تبقى الذكرى عطرة وحاضرة في عقول من رافقوه وعرفوا ما سعى إليه وقُتل بسببه. لذلك، ففي كل يوم يمرّ علينا في حضيض اليأس، يلوح طيفه في الأفق ليقول لي، إنّ بعد العسر يسراً…
لكن، ليس هناك أكثر دناءة من التهجّم على من هم غير قادرين على الردّ أو الدفاع عن أنفسهم. يزداد الأمر شناعة عندما يكون من يتمّ الهجوم عليهم وهم قد غادروا الدنيا. لكن الحقارة تظهر عندما ينبري القاتل إلى اتهام القتيل ويسوغ قتله. هذا هو واقع الأمر في رمي كل آثام التعطيل والتخريب الذي طاول لبنان، قبل وبعد «اتفاق الطائف»، على سياسات الحريري. شعارات تُرمى لتبسط الإجابة، وتزيد على الشعبوية القابضة على العقول، ضلالة إضافية.
لمن ما فتئ يردّد التضليل عن حسن نية، أو عن عقم معرفة، من المفيد أن يعلم. لم يأتِ رفيق الحريري إلى جنة إسمها لبنان، عندما شرع بمسعاه لوقف الحرب، والتي شارك في حفلة جنونها معظم من يرمون تهمة السياسات الخاطئة على الحريري. فالبلد كان يسير في طريق الزوال، بعد أن أصبح منسيًا ومتروكًا في دوامة الموت والدمار. يوم كان القادة الميامين في ساحة الوغى يعطون شهادات الموت لضحاياهم، كان الحريري يمنح الفرص لشهادات جامعية لضحايا مرجحة لأمراء الحرب المتحصنين وراء أجساد الشباب. هذه كانت بداية السياسة الحريرية، فمن جهة سحبت شباباً من ساحة الوغى إلى ساحة العلم، ومن جهة أخرى قلّلت من عدد الشبان الجاهزين للتضحية من أجل أن يرفع أمير ما شارة النصر في حي مدمّر بكامله أو ركام بناء سقط فوق سكانه.
لهذا كان مشروع رفيق الحريري موضع اتهام، حتى قبل أن أتى «اتفاق الطائف»، لأنّه يضع حدًا مؤقتًا لمشاريع أمراء الحرب. للتذكير فقط، عشية وصول رفيق الحريري إلى الحكم، كان الركام يملأ شوارع المدن، والطرق حفرتها القذائف، والمدارس والجامعات والمستشفيات والمطار والاتصالات والكهرباء، كلها في خبر كان. كان جميع من ينعتون سياسات الحريري اليوم، واقفين يتفرجون عن عجز، عن القيام بأي عمل نافع لتغيير المعادلة، وكان أمراء الحرب ينتظرون عودة الفرصة لهم مجدداً.
لم يكن عيبًا أن يتلقف رفيق الحريري فرصة السلام المحتمل بعد مؤتمر مدريد، ليبني مشروعًا قائمًا على هذا الاحتمال، فلا مشاريع عادة تقوم على ترجيح الحرب. لكن العيب، لا بل الجريمة السافلة، تكمن في اصطناع حرب لتخريب مشروع يقوم على احتمال السلام. عندما نسج رفيق الحريري «مؤامرة» نشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان في بداية عهد الرئيس الهراوي، شكاه البعض يومها لحافظ الأسد، فتمّ تخريب المشروع. لقد كان ذاك المسعى يهدف إلى تأمين فرص تطبيق القرار 425، وبالتالي انسحاب الجيش الاسرائيلي من الجنوب. لكن هذا، لو حصل يومها، كان سيعني سحب ذرائع الوجود السوري، وبالتالي تطبيق «اتفاق الطائف» الذي نص على إعادة التموضع على طريق الانسحاب. بالطبع، فقد وضعت تلك «المؤامرة» رفيق الحريري تحت المجهر، ويومها بدأت خطواته الأولى نحو الرابع عشر من شباط. لكن سرعان ما أكمل التطرّف الصهيوني في إسرائيل مسعى إمراء الحرب، فاغتيل اسحق رابين ومعه اغتيل اتفاقا أوسلو ومدريد، وعادت احتمالات الحرب لتطغى على احتمالات السلام. ومن يومها، بدأ التخريب المقصود على سياسات الحريري. فقد بدأت حملات التشكيك والتخوين، ووصلت الأمور إلى دفعه إلى الاعتذار عن تأليف الحكومة في بداية عهد رئيس الجمهورية.
لكن فشل منظومة التعطيل بتأمين، ولو حدّ أدنى من الاستقرار الاقتصادي، وتدهور الاستثمارات المحتملة، على الرغم من مسرحية أكل السندويشات في مجلس الوزراء، أجبر السلطة على الرضوخ بالعودة إلى سياسات الحريري نفسها. كان مشروع «باريس 2» يحمل كثيرًا من الاحتمالات للنجاح في إعادة رسم مسار الاقتصاد، وبالتالي تفعيل خصخصة بعض القطاعات لضمان فعاليتها ونجاحها، ثم التخفيف من عبء القطاع العام على المالية من جهة، وجعله في موضع التنافس لتحسين الخدمات. لكن عصابة التعطيل المقصود دخلت على الخط مجددًا لحصر فائدة المشروع بالمساعدات واستمرار الريعية من دون الإصلاحات.
في النهاية، لم ييأس رفيق الحريري ولم يهرب إلى سفارة ما، ولا اختفى تحت سابع أرض بدهليز لا يعرف مدخله ولا مخرجه. بقي يحاول على الرغم من الصعوبات والمخاطر لمجرد أنّ هناك بصيص أمل واحد، فالانسحاب أو اللجوء إلى سفارة، أو حتى الاختباء، كان سيحوّل الأمل الضئيل إلى صفر. حتى عندما أتى من نَصَحه أن يستقيل من حكومة يتحمّل هو وزر فشلها، مع أنّه لا يملك القرار الحاسم فيها، فقال: «لقد راكمنا بعض النجاحات ولدينا فرصة مع رئيس جديد آتٍ قريبًا، لن أنسحب لأتركهم يدمّرون ما راكمناه». بالطبع، فالجواب عن هذا الكلام كان انفجار الرابع عشر من شباط، الذي يتناساه اليوم بعض العاجزين أو الغافلين.
لكن، من المؤكّد هو أنّ اليوم لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فالحدث عندما يحصل يصبح مباشرة جزءًا من التاريخ، بغض النظر عن تأثيره على حركة التاريخ.
المؤكّد أيضًا، هو أنّ التاريخ مجرد شاهد على الحدث، يكتفي بالتدوين، ولا يأبه بتداعيات هذا الحدث على حياة البشر والحجر والبيئة والشجر، فلا هو يسعى إلى سعادة الناس ولا يتقصّد تعاستهم، وبالتالي فإنّ مسار التاريخ ليس بالضرورة يسير نحو الأفضل بعد كل مفترق طرق أساسي، ابتداءً من ضمور العصر الجليدي الموقت الذي سمح للبشر أن تجتمع خارج المغاور، مرورًا بتدجين القمح وبناء المجتمعات الثابتة، وصولًا إلى الثورات المعرفية والمحطات العسكرية والإمبراطوريات والعلوم وغزو الفضاء والنانوتكنولوجي…
فلو لم يحدث هذا الشيء لكان شيء آخر حدث، ولا يمكن الجزم إن كان هذا الشيء الآخر البديل عن الحدث الحاصل سيكون بالضرورة أفضل أو أسوأ على حياة الناس.
ما لنا ولكل ذلك الآن، لكن المؤكّد أنّ معظمنا يلجؤون إلى كلمة «لو» عندما يكون الحاضر غير ما يتمنّوه!
نقلا عن “الجمهورية”